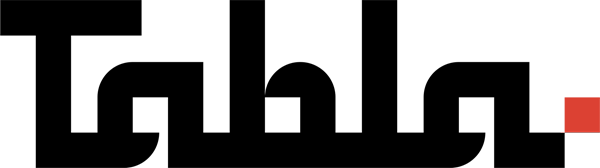ميلتون حاطوم
ترجمة: يارا عثمان
لطالما شكَّلتِ اللّقاءاتُ غيرُ المُتوقَّعة دافعًا للأعمال الأدبيَّة. تماماً كذلك اللِّقاء الذي حدَث بالصّدفة بين إلياس خوري، الكاتب وأستاذ الأدب في نيويورك، و آدم دنون، بائعُ الفلافل و الشّريك في مطعم. يتحدَّثُ آدم اللّغتين العربيّة والعبريَّة بطلاقة، ممّا يُوقِعُ إلياس في حيرةٍ فيما إذا كان آدم فلسطينيًا أم يهوديًا إسرائيليًا. وهذه الحيرةُ هي إحدى معالِم الالتباس التي تنطوي عليها هذه الرّواية العظيمة، حيثما تمتزج الخُرافةُ بالتّاريخ، الخيالُ بالذّاكرة، وحياةُ الشَّخصيات الخاصَّة بمأساةِ شعبٍ بأكمَله.
قبل وفاته بأسبوعٍ في حريقٍ بشقَّته في نيويورك، قام آدم دنّون بتسليم وصيَّتهِ إلى صديقته الكورية سارانغ لي، وهي أيضًا صديقةٌ لإلياس خوري، وطالِبَتُه. وفي نَصّ الوصيَّة، طلَب آدم من الشّابة أن تحرق دفاتره التي تحتوي على مخطوطات لرواية. لكن وعوضًا عن حرقها، قامت سارانغ لي بتسليمها إلى خوري، الذي بدورِه قرَّر نشرَها بالكامل دون أي تدخُّلٍ في النص. فكوَّنت تلك المخطوطات مَتْنَ رواية «اسمي آدم»؛ الجزء الأول من ثلاثيّة «أولاد الغيتو».
في الديباجة الطّويلة التي كتَبَها آدم، يجد القارئ نفسه أمام قصّة الشّاعر الأمويّ وضّاح اليمن؛ أسطورةٌ كالعديد من الأساطير التي كانت و مازالت مصدرًا أساسيًا لبناء الأعمال الأدبية. وفي حالة وضّاح، فهي حقًا أسطورةٌ مروّعة وغايةٌ في الجمال. فيها، يقع ُ الشاعر في حُبِّ روضة، زوجة الخليفة. يمضي نهاره في غرفتها، ويختبئ أثناء الليل في صندوق. يَشكُّ الخليفة، الذي لديه غرفته الخاصة في القصر في أنَّ هناك شخصًا مختبئًا في الصندوق، فيُقرِّر إنزاله في بئرٍ موجود في القصر. لا يقول العاشق شيئًا، أو بالأحرى لا يقوى على أن ينبس ببنت شفة، فيموتُ غرقًا بصمت؛ يصبح الصّندوق قبرَهُ، وتصبح هذه الأسطورة ضربًا قويًا من المَجاز لرواية «اسمي آدم».
إنّ جميع الروايات المعقّدة على المستوى اللّغويّ، والمثيرةُ فكريّاً في أغوالِها الموضوعيّة هي بمثابةِ دعوةٍ لإعادة القراءة. وهذا هو الحال مع «اسمي آدم»، حيث التناصّ والمراجع التاريخيَّة كما الأدبيَّة أمورٌ متكرّرة. من اللّافت أيضًا أنَّ آدم دنون يوجّه في مخطوطاته نقدًا عنيفًا لرواية «باب الشمس»؛ واحدة من أكبر أعمال إلياس خوري. وتبدو هذه السُّخرية الذاتيّة منطقيّةً، لا سيّما أنّ «اسمي آدم» تتبع «باب الشّمس»، التي أبطالها فلسطينيون منفيّون في مخيّمات اللَّاجئين في لبنان. في حين يدور سياق «اسمي آدم» في فلسطين نفسها عام (8491)، العام الذي شَهِدَ حدوث النَّكبة وتأسيس دولة إسرائيل، والذي في شهر تمّوز منه، تعرَّض مئات السُّكان في مدينة اللّد لمذبحةٍ على يد جنودٍ إسرائيليين. ونظرًا لأنَّ آدم دنون كان رضيعًا حينها، فإنّ ما يرويه في دفاتره هي ذكريات والدته (منال) وأستاذه في الطفولة (مأمون الأعمى)، إضافةً لفلسطينيين آخرين شهدوا على المذبحة، وعلى طرْد أبناء بلدهم من أراضيهم. وعلى هذا، يكشِف آدم من خلال العديد من الأصوات وعبر مخيّلتِه أيضاً، جزءاً من القصّة كان مخفيّاً حتى ذلك الحين. ويروي كيف يتحوّل الجامع (المكان المقدّس في اللّد) إلى أحد أوجه جهنّم، و المدينة إلى «غيتو». كما يذكّر بأنَّ «غيتو» هي كلمة أوروبية كان يتداولها الجنود الإسرائلييون، ولم يكن الفلسطينيون ملمّين بمعناها فقاموا بترجمتها إلى «حيّ». ستحمل هذه الكلمة فيما بعد تداعياتٍ حقيقية ورمزيَّة لآدم، الذي عُثِرَ عليه بعد المذبحة حديث الولادة، مُلقى على صدر والدته الميتة، تحت شجرة زيتون.
عندما غادر آدم اللّد متجهًا إلى حيفا، تعلَّم اللغة العبريَّة والتحق بالجامعة. وهناك، ادّعى الشاب النَّحيف الطَّويل، ذو الشَّعر الأشقر المجعَّد، بأنه بولندي، وعرَّف بنفسه على أنّه «ابن الغيتو»؛ المصطلح الذي يفهمه الطلاب والأساتذة اليهود على أنه مرتبط بمعسكر أوشفيتز. أيضًا في حيفا، أُغرِمَ آدم بفتاةٍ يهوديَّة، وبانفصالهما، انتقل إلى نيويورك.
يستكشف إلياس خوري بعمقٍ هذه اللّعبة المعقَّدة للهويَّات، والتي تتعلَّق بشكلٍ أقلَّ بالأُصول، دينيّةً كانت أم عِرقيَّة، وأكثرَ بالعمليَّة التاريخيَّة-السِّياسيَّة التي قادَتها القِوى الاستعماريّة التي احتلَّت فلسطين. وفي هذه اللُّعبة التَّأمُليَّة، تُشير الهُويّة الجديدة لآدم إلى عكسٍ مأساويٍّ للقِيمةِ الأخلاقيَّة؛ إذ يصبح ضحايا الماضي القريب جلَّادين لشعبٍ لم تكُن له أيَّة مسؤوليّةٍ تجاه الهولوكوست، الذي ارتكبَتْهُ دولٌ أوروبيَّة مسيحيَّة ومعادية للساميَّة.
في هذا السّياق أيضاً، يذكر ويعلّق آدم على أعمالٍ كلاسيكية، مِثْلَ أعمال المؤرِّخ الإسرائيلي إيلان بابيه وكذلك كتاب إدوارد سعيد «مسألة فلسطين»، والذي في الجزء الثاني منه وتحت عنوان «الصهيونية من وجهة نظر ضحاياها»، قدّم سعيد دراسةً مفصَّلةً للأيديولوجيا والحركة السياسية والدينية التي دفعت بالاحتلال واستيطان فلسطين. كما يشير آدم إلى رواية «خربة خزعة» التي نُشِرَت في عام (9491)، وهي عملٌ رائعٌ للكاتب الإسرائيلي يزهار سميلنسكي، يسرد خلالها جنديٌّ يهوديٌّ قصّةَ تدميرِ إحدى القُرى الفلسطينية.
وبكلّ الأحوال، فقد تكون «اسمي آدم» أوَّل روايةٍ عن غيتو فلسطين يروي من خلالها النَّاجون، الذين قرَّروا بإصرارٍ البقاء في أرضهم، قصصًا عن حصار اللّد، الاعتداء على المسجد، وإزهاق أرواح المئات من سكَّان المدينة. وتبعًا لأن آدم كان حديث الولادة، فهو يستنجد بذاكرة الآخرين في سردِيَّتِه. ولا شكَّ بأنّ قول ج. ل. بورخيس: “النسيان هو أحد أشكال الذاكرة”، هو التّعبير الأمثل لهذا التناقض، الظاهر فقط، و الذي يضفي المعنى على قصة آدم وفلسطين. ومن هنا تأتي مركزيَّة الذاكرة والصمت والنسيان؛ الثلاثيَّة التي استحضرها آدم مرارًا وتكرارًا بقوله مثلاً:
“فأنا ككلّ الفلسطينيّين الذين فقدوا كلّ شيء حين فقدوا وطنهم، لا أرمي أيّ شيء له علاقة بالذاكرة الهاربة، فنحن عبيد ذاكرتنا” (ص 631).
أو في المقطع التّالي الذي يحمِل لمساتٍ من السُّخرية الذاتيَّة، و الذي تشمُل فيه ذاكرةُ الرَّاوي كلّاً من القارئ ومرور الزمن و فعل الكتابة بذاته: “أكتب الحكاية كي أستعيد ذاكرتي، وأحفرها في ذاكرة قارئ متخيَّل لن تصله هذه الكلمات، لأنّني لست متأكِّدًا من أنّني أريد لها أن تصل. لكن ما معنى الذاكرة؟ أن يبقى حدثٌ أو شخصٌ في الذاكرة يعني أن يتحوَّل إلى سطرٍ ملفوفٍ بما يشبه الضباب. ماذا نذكر من أحبَّتنا الذين رحلوا؟ ماذا نذكر من لحظات الحُبِّ المسروقة؟ […] الحفر في الذاكرة هو شكلٌ للنسيان، نتذكَّر في سياق النسيان”. (ص 293)
لا يشير المقطع أعلاه إلى ما قاله بورخيس فحسب، بل يُحاكي أيضًا، وبشكلٍ مباشرٍ، النثرَ الجميل لمحمود درويش في كتابه «ذاكرة للنسيان»، الذي يروي درويش فيه تجربتَه خلال حصار بيروت في عام (2891).
أن تنسى، لتستطيع لاحقًا إعادة ابتكار فجوات الذاكرة أثناء وعبر الكتابة. ولتحقيق ذلك، فإنّه لمن الضروري الاستماع إلى أصوات الآخرين وقراءة كلماتهم. لقد كان آدم يستمع إلى حكايات عن منال أثناء طفولته و شبابه، ولكن عندما يتذكَّرُها بعد مُدّةٍ طويلةٍ من الزمن، تبدو تلك الحكايات متشظّيةً، متقطعةً، وملفوفةً بالصَّمت، يقول: “وأنا أنسج ذاكرة الصمت من كلام أمِّي” (ص 933). إذًا، فإنَّ الذاكرة تمنَح الزَّمن الحاضر محتوى وفحوى جديدَين، وتكون منطقيّةً بشدَّة عندما تضايُقه وتنيرُه.
قصصٌ أخرى تعترض الرواية هي تلك التي يحيي ذكراها مأمون؛ الذي أقام مع آدم ووالدته في نفس البيت في غيتو اللّد بعض الوقت. وهو أحد النّاجين من اللّد؛ أستاذٌ في القاهرة، كهلٌ وأعمى، و يلقي محاضراتٍ حول الأعمال الشعرية لمحمود درويش. عندما غادر مأمون الأسرة وفلسطين بشكلٍ نهائي، كان آدم في السّابعة من عمره. لكن وبمُضيّ نصف قرن تقريباً، يلتقيان في نيويورك، فيتذكَّر مأمون عدَّة قصصٍ بما في ذلك ولادة آدم، وتفاصيل المذبحة في صيف عام (8491)، عندما “أكثر من خمسين ألف نسمة أُجبروا على مغادرة اللدّ بالقوّة والعنف” (ص512).
من المُحال ألّا تزلزلك بعض المقاطع، كتلك التي تصف “رقصة الضحايا” في اللّد، والتي يُعاد تجسيدها لاحقاً في سبتمبر (2891) في مخيمات اللاجئين في صبرا وشاتيلا (بيروت)، في حادثةٍ شهدت مقتل أكثر من ألفي فلسطيني، بما في ذلك النساء والأطفال والمسنين. وعلى يد ميليشيات مسيحية لبنانية، تحت إشرافٍ وتواطؤٍ من الجيش الإسرائيلي الذي اجتاح لبنان في ذلك العام.
أيضًا عن طريق الصّدفة، يلتقي آدم بناجٍ آخر من اللّد، منفيّ في نيويورك. وبذلك، تتضاعف تدريجيًا أصوات الشُّهود على هذه المأساة وتكسر الصمت، أو بالأحرى الكبت الذي يفرضُه المُضطَّهِد. من الجدير بالذّكر، أنّ هذه الراوية ليست مجرَّد معالجة أمورٍ كالتغاضي، أو الرقابة الذاتية، أو التضليل المُمارَس من قبل معظم وسائل الإعلام الكبرى. بل إنَّ ما تتناوله بعمقٍ هو ما لم يكن قد تم سردُه بعد حول أحداث يوليو (8491)، و كما لو أن الفلسطينيين أنفسهم لم يكونوا على عِلمٍ بمداخل و مخارج تلك الأحداث، وبتفاصيل تاريخهم التي تُمزِّقُها وحشيَّةُ الاستعمار.
عمل إلياس خوري لسنوات طويلة في مخيمات اللاجئين في لبنان وتعايش مع الفلسطينيين. ولا شكَّ بأنّ هذه التجربة كانت غايةً في الاهميّة لكتابته «باب الشمس»، الرواية التي انتقَدَها آدم. علمًا بأنَّ هذه الإزدواجيَّة أو التداعي بين خوري وكاتب «اسمي آدم» تنحدر من تقليد أدبي قديم. فيكفي أن نتذكر أنه في «دون كيشوت»، تم استخدام أسلوب المحاكاة السّاخر هذا بنبرة تهكميَّة. وليس من باب الصّدفة أن يستشهد آدم برائعة ثربانتس، خصوصًا في المقطع حيثما يجد الرّاوي في طليطلة مخطوطةً عربيَّةً للمؤرخ سيدي حامد بن الجيلي، كاتب «دون كيشوت».
وفضلًا عن المحاكاة السّاخرة (الباروديا) آنفة الذّكر، يلعب التناصّ دورًا بارزًا في السرديَّة. حيث الإشارات إلى القرآن والإنجيل، كتُب المؤرخين والشعراء، مؤلفو الروايات الخيالية ونُقَّاد الأدب ليست استشهاداتٍ عشوائية، بل تندمج بشكل عضوي في الموضوع المركزي: كارثة اللّد وفلسطين، والتي لا تزال آثارها الشَّنيعة، بما فيها من المعاناة والوفيات واليأس، قائمةً حتى يومنا هذا. لهذا السّبب، يحاول آدم أن يشرح لدالية، حبيبته اليهودية، عن ماهيَّة العمليات الانتحاريَّة الاستشهاديَّة التي يقوم بها الشُبّان الفلسطينيون، فيقول: “هذه الرغبة في القتل ليست ابنة ذاكرة النكبة، كما يظنّ البعض، بل هي النكبة المعيشة، فإسرائيل حوَّلت حيوات ثلاثة أجيال من الفلسطينيّين إلى نكبة مستمرَّة”.
إنَّ العلاقة العاطفيَّة مع دالية هي علاقةٌ حقيقية، بيد أنَّ اللّاحقيقي هو تلك القصَّة التي ابتكرها آدم لنفسه عندما التحق بجامعة حيفا مُدَّعياً بأنه يهودي من أصل بولندي. ومن المنطقي أنَّ هذه الهوية الإثنيَّة-الدينيَّة الجديدة لم تكن إلَّا محاولةً لقبوله في المجتمع الأكاديمي واندماجه في الدولة حديثة التأسيس. إلَّا أنَّها وبازدواجيَّتِها، وُسِمت بانشطار ممزِّق؛ فالفلسطيني الباحث عن وطن يصبح كائنًا تائهًا، تُخيِّم عليه الذكريات العابرة، التي لا تجدُ ملجأ لها سوى في الكتابة والموت.
يُدرِك الرُّواة، من كلّ بدّ، أنهم عندما يفكِّرون في أحداث الماضي، تظهر الذكريات مشوَّهة، ويصعُب استحضارُها بدِقّة. فيقوم كل راوٍ أو راوية – بما في ذلك آدم، بتحويل الذكريات الضبابيَّة إلى مادة أدبيَّة، كما لو أنَّ مرور الزمن يضاعف احتمالات ذاك المُعاش ويزيد من عمق المسرح الدرامي للذاتيَّة.
الشتات، المنفى، الهولوكوست
لعلَّ إحدى أبرز نقاط الرواية، ولربَّما أكثرها تعقيدًا، هو التَّعامل مع قضيَّة الشتات، المنفى، والهولوكوست. ولذا لا بدَّ من التنويه إلى تعليق آدم على مقالٍ كَتَبَهُ طبيبٌ كان قد قام بمساعدة المصابين في بيروت عام 2891، يقول التّعليق: “أقام [الطبيب] توازيًا بين الطريقة التي تعامل بها النازيُّون مع اليهود خلال المحرقة النازيّة، وبين الأساليب التي استُخدمت في مذبحة صبرا وشاتيلا. أنا لا أحبّ هذا النوع من المقارنات، لأنَّه يُفقد الأشياء معانيها، ويحوِّل علاقة الإنسان بالتاريخ إلى تكرار مملّ، يبرئ المجرم بطريقة مواربة، جاعلاً منه نسخة عن مجرم آخر، ويتعامل مع جرائم الحرب بصفتها قدرًا لا يُردّ! ويحوِّل الضحايا إلى أرقام متجاهلاً فرديّتهم وفرادة مأساة كلّ واحد منهم” (ص312-212).
إنَّ الجهد الذي بذلَهُ آدم يكمن بالضّبط في سرد خصوصيّة مأساة الشّعب الفلسطيني، في علاقةٍ متوترة بين الصمت والأصوات المتعددة للسّردية، وهذا التوتر يحتضن الانقسام الأعمق في روح آدم، كما يجسِّد جميع التناقضات التي يواجهها الفلسطيني على الأرض التي سُلبت منه. ومن هنا جاء هذا الحوار الصّريح مع حبيبته دالية، التي طَرَحَت عليه سؤالًا حيَّرَهُ (على حدّ تعبيره):
ّقالت لو كان بإمكانك أن تختار بين أن تكون قد وُلدت فلسطينيًّا أو يهوديًّا إسرائيليًّا، فماذا تختار؟
قلت لها إنّني اخترتها.
«هل يعني ذلك أنّك اخترت أن تصير إسرائيليًّا»؟
قلت لها، «حاولت أن أكون إسرائيليًّا فلم أكن، لا يستطيع الفلسطينيّ أن يختار سوى أن يكون حيث هو، لكنّني لا أدري».
قالت إنّني لو طرحت السؤال عليها، لأجابت بدون تردُّد بأنَّها كانت ستختار أن تكون فلسطينيّة، لأنَّها تختار الضحيّة.
قلت إنّها تقول ذلك، لأنّ الخيار ليس متاحًا، وهذا يسمح لها بأن تتنعّم بفضائل الضحيّة وامتيازات الجلَّاد.
قالت إنّني لا أفهمها. «ستعلِّمك الأيّام أن تفهمني، وحين تصل إلى تلك اللحظة، ستكتشف معنى أن يكون الإنسان ابن المنفى الدائم، وهذا هو في رأيي الشرط الوجوديّ لليهود، قبل أن تمحو إسرائيل هذا الشرط لمصلحة وجود عبثي لا معنى له» (ص 702-802)
تبدو عبارة “الإنسان ابن المنفى الدائم” التي قالتها دالية استحضاراً لإحدى أجمل مقالات إدوارد سعيد بعنوان «تأملات حول المنفى» وهو أيضًا عنوانٌ لأحد كتبه. ولا شكَّ بأنَّ دالية وبكونها واحدة من الشَّخصيات الرئيسيَّة التي بالتأكيد ستعاود الظهور في أجزاء الثلاثية الأخرى، تكثّف خيوط هذه الحكاية المتشابكة لليهود والفلسطينيين، والتي تعمل بخليط من الهويات والمصائر.
نظرات متقاطعة و مزيج من الأنماط
في التّمهيد الذي كتبه إلياس خوري ليستهلَّ به عرضه لمخطوطات آدم، يستشهد خوري بالفيلم الإسرائيلي «نظرات متقاطعة»، والذي أثارت التشويهاتُ التي يحتويها حُنقَ آدم. لكن فقط في وقتٍ لاحق سيفهم القارئ السّبب الكامن وراء هذا. على كلِّ حال، فإنَّ العنوان لوحده يمكن أن يدلَّ على الكثير: نظرات و أصوات تتقاطع في مراحلٍ زمنيّةٍ مختلفة وفي حركةٍ دوريَّة ومتكرَّرة، لكن لاخطيَّة. أيضاً في التمهيد، يقول خوري أنَّ دفاتر آدم “تتضمَّن نصوصًا غير مكتملة، تتراوح بين الرّواية والسِّيرة الذاتيَّة، وبين الواقع والتخييل، و تمزج النّقد الأدبي بكتابة الأدب”. هذا المزيج من الأنماط الخطابيَّة واللُّغويَّة يبدو لي موضوعيَّاً لإعداد هذه الرِّواية؛ إذ يبدأ آدم بالحديث عن أسطورة وضّاح اليمن وشعرِه الهائم، لكنّه يقاطعه ليسرد ذكرياته الخاصَّة بلا أيَّة بهرجة. و هنا تعمل الأسطورة كنموذج بدائيّ للسرد، وتلعب دورًا مهمًا لتطوير الحبكة والمعنى الرمزي لـ «اسمي آدم»، حيثما حياة البطل منذ بداية احتلال فلسطين هي المحور المركزي للرواية، والتي يشدّد وجهها الواقعيّ على مشاهد ملموسة للعنف والقتل والطّرد والإذلال. أمَّا بشأن الأسطورة الملحميَّة، التي تشمل موت وضّاح اليمن بصمتٍ في الصّندوق المرميّ في البئر، فهي ترمز إلى النُّزول إلى عالم الموت الجحيميّ، المُعاد تمثيله في الخصائص التاريخيّة التي يعلَمُها إلياس خوري جيِّدًا. وبهذا، تنضمُّ أصوات النّاجين لأصوات الموتى في الجوقة المؤلمة ذاتها، وبقيادةٍ من آدم:
“[…]وبدل قتل الذاكرة بالاستعارة، كما حاولت أن أفعل من خلال عملي الروائيّ المُجهَض عن وضّاح اليمن، سوف أكتبها محوِّلاً إيّاها جثّة من كلمات” (ص 79).
التّرجمة
أشار فالتر بنيامين إلى أنَّ الترجمة تُعبِّر عن العلاقة الأكثر حميميَّة بين لغتين، وذلك بإنشائها لتقارب أصليّ بينهما. ووفقًا للفيلسوف الألماني، فإنَّ هذه العلاقة تتمثَّل في حقيقة أن اللغات في الواقع ليست غريبةً عن بعضها البعض، وقبل كلّ شيء، وبصرف النّظر عن جميع الاعتبارات التاريخيَّة، فإنَّ صلة القرابة التي تجمعها تكمُن فيما تنوي اللّغات أن تقوله وتقصده. بناءً على ذلك، أعتقد أنّ التّرجمة المميّزة التي قامت بها الأستاذة صفاء جبران تتناسب مع هذا المبدأ البنياميني. صفاء التي ترجمت روايتيّ «باب الشمس» و «يالو» لإلياس خوري، تكشف مرّةً أخرى عن موهبتها الفذَّة في إنشاء التّقارب الأصلي آنف الذكر بين اللغتين البرتغاليّة والعربيّة، كما عن كفاءتها في التقاط الإيقاع، والصور، والنغمات/النّبرات المختلفة لأصوات النصّ الأصلي. ومن الممكن للقارئ أن يُدرِك ذلك حتّى في أصعب المقاطع، كتلك التي تحمل مناجاة آدم لنفسه أو التي يصبح فيها النثر شِعراً. كما يمكنُه استشعار حسٍّ تشكيليٍّ نادر، دون أن يفقد القصد الذي يسعى إليه الرّاوي وهو: فهم واستيعاب الكارثة الفلسطينيّة. وأخيراً وليس آخراً، سيسمع القُرَّاء القصَّة التي تمّ كتمانها، وذلك بمجرَّد الانتهاء من قراءة هذه الرّواية التي تهزّ الأنفس.
Leia o texto em português aqui!